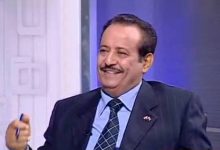عُمان .. نموذج للتعايش المذهبي

يمنات
لطف الصراري
عندما فكرت بالكتابة عن التعايش المذهبي في سلطنة عمان، تساءلت: هل كل من يزور هذا البلد يلاحظ التعايش الذي تعكسه مساجدها، أم أن الأمر يقتصر على من تعيش بلاده حرباً..؟ في الواقع، لا يقتصر الأمر على من يتجول في شوارعها، إذ يكفي أن تكتب في خانة بحث جوجل: “التعايش المذهبي…” ليظهر في أول خيارات التكملة التلقائية للبحث: “في سلطنة عمان”. أعتقد أن أي زائر عربي أو مسلم إلى مسقط لن يفكر بالبحث عن نموذج لتعايش من هذا النوع في أي مكان آخر. إنه النموذج الأقرب، والنقيض لما أحدثه الصراع بين السنة والشيعة في المنطقة. فإضافة لهذين المذهبين، يشكل المذهب الأباضي ما يمكن اعتباره محور التوازن، خاصة مع امتلاكه أدوات السلطة لترسيخ هوية وطنية جامعة للعُمانيين تجعلهم في غنى عن تعريف أنفسهم بهويات طائفية.
ثلاثة مذاهب إذاً، تتعايش في ظل دولة لا تبدو غافلة عن أهمية تكريس مبدأ التسامح الديني، لحماية النسيج الإجتماعي واستقرار الحياة فيها. لا يتعلق الأمر فقط، بتقدير خطورة إهمال الخلافات المذهبية في مهدها، بل أيضاً في تكثيف الجهد الرسمي لضمان عدم الشعور بالغبن لدى أتباع هذا المذهب أو ذاك، نتيجة المنع الكامل لمظاهر الاختلاف بينهم. فحين يرتفع الأذان مثلاً في مسجد ما، يكون من السهل معرفة إذا ما كان هذا مسجداً ذا طابع سني أو شيعي.
إضافة لذلك، تظهر أوجه الإختلاف المشروعة حتى من خلال تصميم المآذن والقباب، والشكل الهندسي للمسجد عموماً. وهذه إحدى السمات التي تشير إلى أن التعايش المذهبي لا يعني دمغ المظاهر الدينية وشعائر العبادة بطابع واحد، أو فرض توليفة توافقية لتعميمها كنمط ضامن للتعايش. فالقبول بالآخر، الذي يعتبر جوهر مبدأ التعايش، يشمل ضمور الحساسية بين المذاهب إزاء تعبيرات الشكل والمضمون. وهنا لا يحتاج مفهوم التعدد إلى تعريفات فضفاضة.
في ديسمبر الماضي، أتيحت لي فرصة العبور من عُمان لكي أتمكن من ركوب طائرة إلى الكويت. تعاملت مع تلك الزيارة الإجبارية كفرصة، لكي أجبر نفسي على تحمل رحلتي الطويلة والشاقة. وقد كانت فرصة بالفعل، لمست فيها عن قرب ذلك الود الكامن والمعلن الذي يكنه العُمانيون والكويتيون لليمنيين. في الدور الخامس من فندق دلمون بمنطقة الوادي الكبير، التي كانت إلى ما قبل خمس عشرة سنة مركز العاصمة ومؤسساتها الحكومية، أصغيت لآذان الظهر. بعد أن قال المؤذن: “أشهد أن محمداً رسول الله” للمرة الثانية، قال بنفس الوتيرة: “أشهد أن علياً ولي الله… أشهد أن علياً حجة الله”. لوهلة، انتابني ذعر خاطف، ولاحظت للمرة الأولى كيف تستدعي الأحداث المؤلمة نفسها بسرعة البرق، من الذاكرة اللاواعية للإنسان. فكم شهدت مساجد صنعاء وغيرها من المدن اليمنية من مواجهات مسلحة بسبب خلافات حول صلاة التراويح، أو حول دعاء القنوت في صلاة الفجر..؟! وكم من المخاوف تنمو مع نمو الحساسية تجاه ترديد شعار “الصرخة” الخاص بجماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، لاسيما بعد خطبة وصلاة الجمعة..؟!
في جميع الصراعات القائمة على الدين واختلاف المذاهب، لا يمكن تلمّس بداية للتعايش بعيداً عن المكان الذي انطلقت منه الشرارة الأولى للصراع: دور العبادة ومؤسسات التعليم. وقد سمح اليمنيون لاختلافهم المذهبي أن يتصاعد إلى صراع في المساجد، وأن يخرج إلى ساحات قتال أوسع. كما سمحوا للصراع المتفاقم بأن يدخل مؤسسات التعليم الرسمية وأن يجر معه آلاف الفتيان إلى استرخاص الحياة في سبيل استئصال الآخر المختلف.
و في وضع كهذا، لن يجدي الحديث عن “مؤامرات” خارجية ضد اليمن والاسلام، ولن يجدي تبادل الإتهامات بالعمالة لأمريكا أو السعودية أو إيران. لن يجدي ذلك، لأن كل طرف مازال يتحدث عن إسلام يخصه ويمن يخصه هو، بينما يعتبر وجود الآخر تهديداً لبقائه بالضرورة.
خلال مراحل مختلفة من عمر الحرب الدائرة في اليمن، إستضافت مسقط عدة جولات واجتماعات، معلنة وغير معلنة، لتقريب وجهات نظر الأطراف المتحاربة. مع ذلك، لم يؤثر فيهم مشهد التعايش الذي يغمر المدينة بالطمأنينة، ويبعث في النفوس رغبة ملحة للعيش بسلام. يكذب من يقول إنه لا يتوق للعيش بسلام، حتى قادة الحرب أنفسهم، لكنها لعنة التيه والمكابرة وضعف الثقة بالنفس وبالآخر، هذه التي أصابت اليمنيين ولا يعلم سوى الله وحده متى تزول.
للاشتراك في قناة يمنات على التليجرام انقر هنا